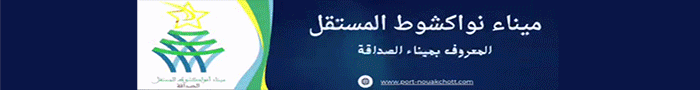المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسي
صلابة الموقف وتعدّد أساليب المواجهة

الزمان أنفو _ لقد استمرت المقاومة الموريتانية ضدّ الاستعمار الفرنسي عدة عقود، وتعددت وتنوعت أساليبها على امتداد المجال الموريتاني، حيث اتخذت أشكالاً مختلفة من الصولات المباغتة، والغارات الخاطفة، والكمائن المحكمة، والالتحام المباشر. وهذا ما يبرهن عليه المستوى النوعي لمعركة المقاومة التي تجاوزت المائة، استُشهد فيها نصف أمراء البلاد يومها، وأهم قادتها العشائريين، والمئات من المجاهدين.
وفي المقابل، كانت خسائر الفرنسيين كبيرة؛ فقد قُتل قائد جيش الاحتلال ومنظّر المشروع الاستعماري كبولاني، مع عشرات من قادته الميدانيين، ومئات من جنوده في مواقع عديدة مثل ميّت، وبوكادوم، وتجكجة، والنيملان، ولكويشيشي، وتِشيت، ولبيرات، والمينان، ووادي التكليات، ووديان الخروب، وأم التونسي، وميجك، وغيرها من أيام المقاومة. وقد اعترف الفرنسيون بخسارة أكثر من 700 جندي، وواحد وعشرين ضابطًا في مناطق آدرار والساحل وحدها خلال الفترة من 30 دجمبر 1908 إلى 14 مارس 1932.
وعلى الجبهة الثقافية، مثلت مقاطعة المدرسة الاستعمارية سلاحًا آخر من أسلحة المقاومة. كما كانت المحظرة والزاوية والمسجد دروعًا واقية للهوية العربية الإسلامية، وصمامات أمان لقيم المجتمع وموروثه الحضاري. وفي هذا السياق يعترف أحد المسؤولين الفرنسيين الذين حكموا موريتانيا إبان الفترة الاستعمارية بنجاح المحظرة في أداء رسالتها، مؤكدًا أن:
> “المحاظر قد تمكنت، على العموم، من الصمود في وجه الغزو الثقافي الأجنبي، واضطلعت برسالتها المتمثلة في صيانة تراث ثقافي يمثل بالنسبة لها مدعاة فخر واعتزاز”.
لم يكن الشعراء بمنأى عن هذه الأحداث؛ فقد نظموا قصائد ثورية تستنهض الهمم في وجه المدّ الاستعماري الفرنسي، دفاعًا عن مقومات الأمة: لغتها، ودينها، وأرضها، وسيرًا على نهج المقاومة.
كما تجلت الممانعة الاجتماعية في عدة مظاهر كانت بدورها شكلاً من أشكال المقاومة، من أبرزها:
– الهجرة الفردية والجماعية لبعض العلماء والجماعات إلى خارج البلاد التي غلب عليها المستعمر.
– الهروب من سكنى المدن خشية الاحتكاك بالفرنسيين.
– رفض الخدمة العسكرية.
– مقاطعة المنتجات المستحدثة وغير المحلية.
وقد كان العالم محمد بن الطالب إبراهيم التاكاطي (ت 1375هـ) لا يستعمل الألبسة التي فيها خياطة غير محلية، ولا يستعمل لحيواناته الحقن أو الأدوية التي ينتجها النصارى.
– رفض البعض أخذ الهدايا والجواري من الحكام الفرنسيين ومعاونيهم من أهل البلاد.
– الامتناع عن دفع الضرائب أو التحايل على تسديدها.
لقد تميزت المقاومة بالوجود المكثف للعلماء والأمراء والقيادات العشائرية الذين كانوا في مقدمة ركبها، وفي أغلب معاركها على عموم التراب الموريتاني. غير أن ذلك لا يعني غياب فئات المجتمع الأخرى، التي ساهمت كلٌّ بحسب قابلياته ووظيفته الاجتماعية، عبر التأطير الديني، وصناعة السلاح، وتأمين الأقوات للمجاهدين، والمشاركة الميدانية في المعارك، ومهام الاستطلاع والدلالة، وسقاية المقاتلين، ورعاية جمالهم، وسياسة خيلهم.
وقد شاركت النساء في المجهود الحربي عبر نصب الخيام، وإعداد الطعام، وتضميد الجراح، وتحريض المقاتلين على الثبات.
إن توفر هذه العوامل مجتمعة شكّل الأسس الموضوعية لاندلاع مقاومة مسلحة قوية ارتبط نشاطها بحماس ديني كبير، وأثبتت كفاءتها في العديد من المواقع باعتراف الفرنسيين أنفسهم.
وعلى الرغم من أهمية هذه المقاومة في صَون الهوية الثقافية، وتأخير إخضاع البلاد للاستعمار الفرنسي مدة معتبرة، فإن تراجع المقاومة المسلحة ساهم في الاستقرار التدريجي للمستعمر الفرنسي في البلاد. ورغم ذلك، فقد وقفت الشخصيات الوطنية في وجه المستعمر، وإن لم تستطع منع سقوط البلاد، لكنها قدّمت نموذجًا عظيمًا في التضحية والفداء.
وظلت هذه الشخصيات من علماء ومجاهدين وأمراء تترقب الفرصة لمعاودة الكفاح، حتى نجحت الحركة الوطنية في موريتانيا وفي غيرها من البلدان الإفريقية في تحقيق أهدافها عقب الحرب العالمية الثانية. فجاء عام 1960، وهو بحق عام إفريقيا، حيث استقلت عدة دول من غرب القارة وشرقها ووسطها، ومن ضمنها بلادنا، فاضطر المستعمر إلى حمل عصاه والرحيل.
الشيخ باي ولد محمد الأمين
صحفي وباحث